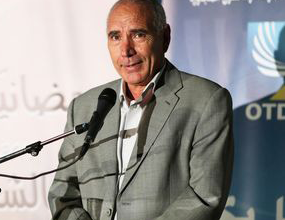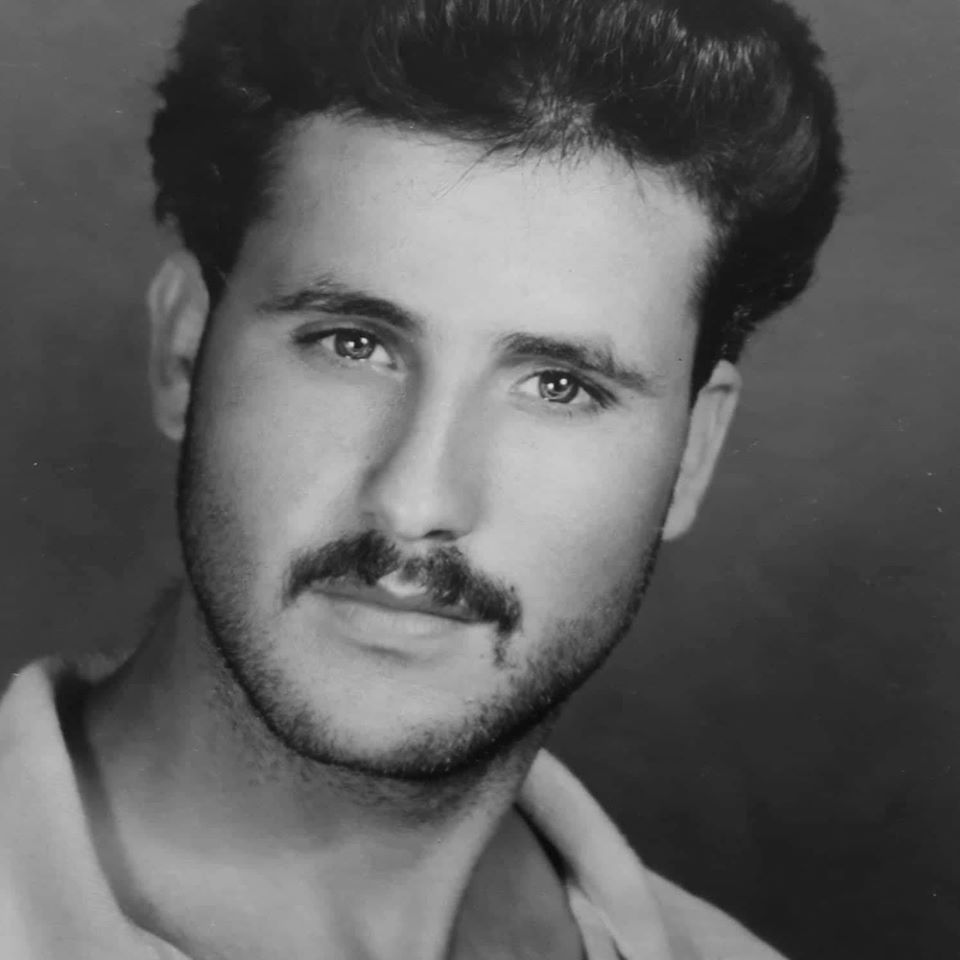لماذا المسرح؟
سؤال يبدو ساذجاً في نظر العامّي، ولكنّه في غاية الخطورة، يذكرني الآن بسؤال الشاعر الألماني هولدرلين: “لماذا الشعر في أزمنة البؤس؟”. ولذلك فإنّه سؤال يمتلك وقع الرجّة، إنّه علامة جذرية على الوعي بأزمة مّا، وعلامة اعتراف بشقاء وجودنا المسرحي على أن يكون الهدف منه السير نحو ممكن أفضل.
في الحقيقة، نحن لا نستطيع الإجابة عنه إلا على نحوٍ غضبي وعدائي حين يطرح علينا من قبل جهة أخرى غير جهة المسرحيين. فهو يعكس احتقاراً لهذا الفنّ، وخاصة حين يأتي من قبل رجل السياسة أو رجل الدين أو الجهاز الأمني للدولة، ولذلك فهو سؤال يأتي بشكل ساخر. إنّ مهمّة المسرح هي الإضرار بهذه السخرية وتدمير التفاهة بجعلها أمراً مخجلا، إنّه يوجد لكي يمنع الفكر من السقوط في السفالة ومن النمطية والسذاجة التي تكرسها الدولة بأجهزتها السياسية والإعلامية أو المسجد بوصفه مصنعاً لتعليب الأفكار في بعد واحد، إنّه يوجد ليصنع أحرارا بوصفه تمارينا صعبة على ممارسة النقد وتوليد المعنى ولا يحتكم لحقيقة واحدة، ولذلك فإن الممارسة الحقيقية لهذا الفنّ من شأنها جعل التفاهة التي تسري في الفضاء العام أمرا مقززا ومخجلا.
في المقابل، سنرتبك ونحن نبحث عن إجابة لسؤال لماذا المسرح حين نطرحه نحن كمسرحيين، لأننا في هذه الحالة نقيم في حضرة الشك، الشك في تجاربنا المسرحية سواء كانت ممارسة إبداعية أو تنظيرية أو نقدية، وهو شك يقودنا إلى الاعتراف بأنه ثمة أزمة مّا، أزمة جعلت من وجودنا المسرحي متقوقعا على أناه، ولا نعرف في هذه الحالة إن كان سبب هذه الأزمة هو نحن بوصفنا نعجز عن تقديم نماذج مسرحية تمثل سردية كبرى تمسرح آلامنا وهواجسنا وواقعنا الذي نعيش، أو هي راجعة إلى حجم الحصار المفروض على المسرح والمسرحيين من خلال المؤسسات المسرحية للدولة أو راهن السوق والسياسات الإنتاجية وعقم الحياة الثقافية ككل.
يبدو أنّ هذا السؤال لن يجد ترحيبا من أحد، ستشهد الجهة التي تطرحه اعتراضا عنيفا من قبل المسرحيين لأنهم في ذلك بقدر ما يدافعون عن وجود هذا الفنّ يدافعون أيضا عن وجودهم الخاصّ إذ كيف يمكن أن نتحدث عن مسرحيين دون مسرح؟ ولكنّ المسرحيين أنفسهم لن يرحبوا بهذا السؤال حتى وإن خرج من أفواه المسرحيين أنفسهم، لأنه بهذا الشكل سؤال يعيد المسرحيّ إلى مراجعة خياراته وما إذا كان ممكنا أن يتورّط في مجال آخر غير مجال المسرح؟ لا يطرح هذا السؤال بالجرأة الكافية من المسرحيين إلا مسرحيّ حقيقيّ، لأنّه مسرحي لا يخاف من تجربته الحيّة، ولأنه مسرحي غامر بالانتماء إلى المسرح وجعل من هذه المغامرة قرارا مصيريا، ولأنه مسرحي لا تزعجه محاكمة نفسه حين يتحدّد وجوده المسرحي في شكل أزمة، ولذلك فهو ينظر إلى سؤال “لماذا” بوصفه سؤالا دالّا على الوعي ومثيرا للاستغراب أمام الإحساس بغربة الذات في الوجود.
لماذا المسرح؟ طبعا، يجب أن نسخر في هذه الحالة من تلك الأصوات المنادية بضرورة المسرح كي تقتات من عروضه وتجعل من هذا الفنّ وسيلة معاشها. يا للسخرية: هل نريد مسرحا كي نطعم بعض الجياع الذين أقنعونا بأنهم هم وحدهم المتكلمون باسم المسرح؟ لقد ارتبط لدينا هذا السؤال من زاوية رفض الحالة الاجتماعية الظالمة لبعض المسرحيين كما نشهد وقائعها اليوم، ولأن المسرح كما ذكرت سلفا طاقة رافضة لكافة أشكال التفاهة فقد تمّ ترذيله أكثر عبر أشكال الرفض التي قدمها المسرحيون أنفسهم بوصفها أشكال نضالية منحطّة، ولذلك نحن هنا لا لنقيم مأتما حول وضع المسرحيين الذين يطرحون هذا السؤال ببطونهم، بل لنفكّر في المسرح على نحو أسمى.
تاريخيا، أعتقد أن هذا السؤال لم يكن ليطرح، لأنّ المسألة محسومة من حيث اشتغال المسرح، فمنذ قرون مضت صاحبت فلسفة القرن الرابع قبل الميلاد – ممثّلة في أرسطو ومن قبله سقراط بوصفه قناعا أفلاطونيا-، التراجيديا الإغريقية، ومارست عليها ضربا من الشرح أو التقنين أو الإقصاء، لكن لا أحد يمكنه أن يتخيل اليونان القديمة دون يوربيدس وأسخيلوس وسوفكليس: تخيلوا لو لم يكن هناك شاعر اسمه هوميروس أوصل إلى العالم برمته نبأ انتصار الإغريق على طروادة؟ لماذا المسرح أنذاك؟ لأنه حبر المدينة وتاريخها وضميرها، لأن المسرحيون والشعراء أنذاك لا يقلّون شأنا عن المقاتل أو السياسي بل هم أعلى شأنا، ولأنه لو لا وجود المسرح أنذاك لما كان هناك وجود لتلك الفلسفة التي تدرّس حتى اليوم في الجامعات الغربية والعربية، ولو لا وجود المسرح أنذاك لما قدّم لنا فرويد عالم النفس تلك الترسانة من المفاهيم على نحو عقدة أوديب وعقدة إلكترا مستأنسا في ذلك بإعادة تشغيل التراجيديات والأساطير الإغريقية القديمة.
يمكننا الآن تنشيط سؤالنا من خلال نموذج حديث، إذ منذ سنة فقط وقّع بيتر بروك عرضا مسرحيا تحت عنوان “لماذا” كان مايرهولد نموذجه الممسرح، والمقصود في حالة كهذه هو لماذا الممارسة المسرحية أو لماذا المسرح في عصر تغيب عنه السرديات العظيمة والأعمال المسرحية الكبرى كالتي كانت تحدث قديما ووصلتنا أخبارها؟ وبالرغم من أننا لم نر العرض حتى يتسنى لنا تقديمه على نحو كاف، إلا أنه يمكننا الإجابة عن سؤالنا (لماذا المسرح) من خلال ذلك التصريح الذي ورد في العرض على نحو طريف للغاية، إذ أنّ الله هو الذي خلق المسرح كي يُريح البشر من قلقهم ومللهم وهم يعيشون هنا على الأرض.
المسرح وقلق البشر. ليس القلق مفهوما نفسيا في هذا السياق، ولكنه نتيجة لشكل سكن الإنسان في المدينة، بوصفه حمّال أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية بالأساس. ولذلك، فإنّ المسرح هو الفنّ الذي يحاكي شكل هذا السكن على نحوٍ لا استنساخ ولا تقليد فيه، بل على نحو جمالي وفني ورؤيوي لا يخلو من التخييل واستبصار المستقبل، والمسرح أيضا هو القوّة الفاعلة والنشيطة داخل الفضاء العمومي، وهي قوّة من شأنها تدمير ما يشدّ الإنسان للعيش في فضاء المدينة بوصفه رقما أو عبدا في سوق الرقيق السياسي كما نشاهده اليوم، لا بوصفه مواطنا.
لا معنى إذن لطرح سؤال لماذا المسرح خارج سياق الفضاء العمومي الذي ننتمي إليه سواء كنّا فاعلين فيه كمواطنين أو كأفراد بلا إرادة أمام سلطة مّا. ولذلك فإننا نطعّم هذا السؤال بسؤال آخر: ما موقع المسرح في هذا الفضاء ولماذا يجب أن يكون له دور فعّال فيه؟ تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الفضاء العمومي مفهوما نحته الألماني هابرماس، وترجمته الحرفية إلى اللغة العربية كما انتبه إلى ذلك المسكيني تعني “الفراغ العمومي”. قد لا تخدعنا اللغة أحيانا، فنحن فعلا نحيا في فراغ عمومي، ولكن من يعمّر هذا الفراغ؟ ما معنى أوّلا الفضاء العمومي؟ إنه “المجال التاريخي الذي يكوّن الرّأي العام ويحكمه”، وهو أيضا “إطار قانوني نهائي لكلّ قدرة على التعقّل اليومي لمعنى المواطنة”، ولهذا لا معنى إطلاقا للحديث عن فضاء عمومي دون استعمال عمومي للعقل يجد مجالاته في المجلات والنوادي والصالونات الأدبية ووسائل الاتصال والمسارح وغيرها، وبالتالي يكون التأثير لا سياسيا واجتماعيا فحسب وإنما أيضا ثقافيا وجماليا، ولا معنى أيضا للحديث عن فضاء عمومي لا يهتم بقضايا العيش المشترك ولا يعلن عن قيم المواطنة وتربية الأفراد على ممارستها. في هذا الفضاء لا تنشأ سلطة الدولة التي يستمدّ من جهازها الحقوقي شرعيته فحسب، إنما ثمّة أيضا سلطة مضادة كسلطة المجتمع المدني، ولهذا فهو فضاء مدني له جغرافيته الخاصة به. هكذا باقتضاب يمكننا تعريف الفضاء العمومي بالاستناد إلى هابرماس. ولكن ما طبيعة الفضاء العمومي لدينا؟ وما هي الأجهزة التي تتحكّم فيه؟ ولماذا المسرح كقوّة يجب أن تدخل مجاله وتنافس أجهزته تلك؟
ما يحتكم إليه هذا الفضاء هو ثلاثة أجهزة قمعية حدّدها المسكيني في كتابه (فلسفة النوابت) كالآتي: آلة التخييل التي تقدّمها الملّة وهي المسجد ثم آلة العنف الشرعي للدولة وهي الثكنة، وأخيرا آلة الدرس وهي المدرسة أو الجامعة. تتميّز الآلة الأولى بالانغلاق والتحجر والدوغمائية، ولذلك فهي تشرّع للاستئصال والقتل والدم نتيجة ارتهانها لمنطق الحقيقة المطلقة، وتتميّز الثانية بالمراقبة والمعاقبة، ولذلك فهي لا تتمثّل وجود المجتمع المدني إلا نحو الصراع والمحاكمات، وتتميّز الثالثة باجترارها الفكر المجرّد والقديم، ولذلك هي لا تنتج مفكرين بل تنتج تقنيي معرفة، ولا تنتج فلاسفة أو مبدعين بل مدرسين وموظفين عموميين. هكذا يمكن القول بأننا لا نعيش في فضاء عمومي كالذي حدّده هابرماس، وإنما نعيش في مصنع بين الآلات، وهنا نستدل بما صرح به المسكيني بالقول“إن هذا الوضع العمومي إنما يدفع إلى اليأس حقا عندما نعرف أن العلاقات بين عقل المدرسة وعقل المسجد وعقل الثكنة أو المحكمة، إنما هي علاقات غير تواصلية أساسا، بل هي عنفية أو لا مبالية أو غامضة”.
على هذا النحو من سكننا في هذا الفضاء، سنشهد ضربا من إعدام الانتقال الديمقراطي الحقيقي، وضربا من غياب المواطنة، وضربا من المراهنة على الساذج والرديء وسيطرة المزيفين في البرلمانات وتفشي التسطيح الإعلامي ومولد رهط جديد من منتجي الخردة الفنية، ولذلك فإنّ المناخ العام برمته لا يمكنه الترحيب بالمسرح، ولذلك أيضا فإن طرح سؤال لماذا المسرح من جهة الحالة الاجتماعية الظالمة لبعض المسرحيين سيلحق ضررا بالمسرح لأن ذلك ليس دوره الحقيقي، بل دوره هو اقتحام هذا الفضاء كطاقة تخرّب أجهزته التي تحدثنا عنها، بل وتخترقها من أجل أن ينخرط المسرح في صناعة الرّأي العام على نحوٍ يكون فيه استخدام العقل عموميّا لا عامّيا.
إننا نحتاج جسرا يربط بين الأجهزة الثلاثة التي ذكرنا، وهذا يبدو مستحيلا إلا إذا حرّرنا الله الإسلامي من سجن المسجد والنظر إليه كطاقة روحية لمؤمن لا يحتاج إلى مؤسسة دينية تثبت إيمانه أو إلحاده، وإلا إذا حرّرنا المدرسة من سقوطها في اجترار الأجوبة الموجودة سلفا في الكتب والدفع بها لتصبح فضاء خلاقا لإنتاج الفكر، وإلا إذا حرّرنا الثكنة من الحاكم الهووي الذي لا تستهويه إلا السلطة المطلقة.
إنّ المسرح وحده قادر على فعل ذلك، أن يكون أداة التحرّر هذه، فقد ولد منذ قديمه من رحم الأساطير والاحتفالات الجمعية، وعلى الرغم من أنه يشتغل الآن دون ميثولوجيا لأننا نحيا في أفق معاصر لا أساطير له، إلا أنه مازال حدّ الآن يحتفظ يطاقته المدهشة على روحنة العالم، ولذلك بدلا من الانخراط في مواجهة مؤسسات الله ونقاباته كما لو أنه يلعب دور المدفع، يمكنه إعادة ترميز وجودنا على نحو جمالي وهنا سينخرط في المقاومة لا المواجهة، وهنا يمكنه تدمير آلة التخييل المسمّاة مسجدا واستبدالها بأفق روحي جديد يخلّص الإنسان من تفاهة اليومي.
أجري هنا، على سبيل المثال لا الحصر، مقارنة جريئة بين مسرحية المجنون لتوفيق الجبالي ومسرحية تسونامي للفاضل الجعايبي، وذلك من حيث السؤال على المسرح كإقامة في الفضاء العمومي، الأولى تمارس فعل الاختراق، تصنع الحدث، تكنس اللاهوت الإسلامي بتجاهله، تقدم مناخا روحيا مغايرا وغير ملوّث أو مشوّه كالمقدّس الديني القائم على تشغيل الدم، تبذر الأمل، تهبنا إمكانية السكن في الفضاء العمومي على نحو يكون فيه الإنسان حرّا، ولذلك هي لا تعطي تصورا عن حدث زائل ستموت بموته، بل تفصح عن رؤية للعالم. ومنطلقها في ذلك كتابة مختلفة لكاتب مختلف هو جبران خليل جبران. أما الثانية فهي تجعل من المسرح سلاحا، لا تصنع الحدث بل تردّ الفعل عليه على نحو بافلوفي، تنخرط في الصراع الدائر بوصفه صراعا سياسيا دون مرجعية جمالية، ولذلك فهي لا تتحقق إلا بوصفها في تبعية لآلة العنف الشرعي (الثكنة) في مواجهة آلة التخييل المسجد، ولذلك أيضا ستنتهي بنهاية الحدث الذي أنتجها. على العكس، إن مسرحية المجنون تمثل ضربا من اختراق الآلتين، تقوّض مركزية المسجد وفي نفس الوقت تقدم شكلا للمقاومة لا ينحاز لآلة العنف الشرعي: إنها تقدم بدائل جمالية للفضاء العمومي الذي نسكنه.
ما أريد قوله هنا، هو أن للمسرح طاقة اختراق للفضاء العمومي شريطة أن يتحرك على نحو المقاومة لا المواجهة، ومثلما يمكنه أن يحلّ بدل المسجد بشكل يصبح فيه مقدسا جماليا وروحيا، يمكنه أيضا اختراق آلة العنف الشرعي (الثكنة) وآلة المدرسة أيضا. إن المسرح يبدأ من اللحظة التي ينتهي فيها كلام تلك الأجهزة، لأنه ليس واحدا منها، ولأنه لديه دائما ما يقوله، ولذلك فهو مخوّل لإعادة تربية الإنسان الذي أنتجه هذا الفضاء على نحو جعل منه مشتتا وممزقا وغريبا ومغتربا عن واقعه: إنّ المسرح على هذا النّحو هو الواقعة الجمالية والفكرية التي تحلّ في الفضاء العمومي وتعمل على تشغيل العقل عموميّا لا عامّيا.
إنّ سؤال لماذا المسرح هو سؤال قلق يعترض على أزمنة البؤس، وهو سؤال يجب أن لا نسمح لأيّ كان بطرحه حتّى لا يتلوّث، وأن نطرحه فمعناه أننا نسأل عن الدستور الجمالي للمسرح وطبيعة إقامته في الزمان والمكان.
طبعا، لم يكن الله هو الذي خلق المسرح كما وصلنا مزاح بيتر بروك، ولكن يبدو أن علّة هذا الفنّ تأتي من قلق البشر فعلا، قلقهم القديم حين أنتجوا الأساطير والظواهر الاحتفالية والأشكال الفرجوية تمعينا لوجودهم، وقلقهم القديم أيضا حين احتاجت المدينة وجود الشعراء التراجيديين والكوميديين يقولون محنة الإنسان وأقداره وهو يصارع الآلهة، وقلقهم الحديث أمام توحّش السوق وصحوة الأصوليات المعاصرة، ولذلك كان هذا الإنسان يحاكي واقعه على نحو جمالي دائما، أو ينتصر على الألم لا بالهروب منه بل باللعب معه، ولذلك فإنّ المسرح على الرغم من أنه طاقة هائجة من مهماتها تخريب البؤس الاجتماعي والسياسي والثقافي، فإنه أيضا شكل آخر من أشكال سكننا الوجود.
لماذا المسرح إذن؟
لكي نمسرح فواجعنا وآلامنا وشتاتنا التي نعيشها الآن، لكي نمسرح هذه المسوخ السياسية والثقافية والإعلامية وغيرها من الأشباح المفزعة على نحو دحضها، لكي نمنح لسكننا في هذا الفضاء العمومي بعدا جماليا، لكي نستلّ الأمل من مخلب الكارثة، لكي ندرّب أنفسنا جيّدا على الإنسانية، لكي نتعلّم الهجرة إلى المستقبل، لكي نعرف الطريق السالكة بنا من التوحّش إلى التمدّن.
لماذا المسرح إذن؟
لكي نختبر ذواتنا: ما إذا كنّا بشرا على قلق دائم أم محض خردة آدمية أغلقت باب التفكير في تاريخها.