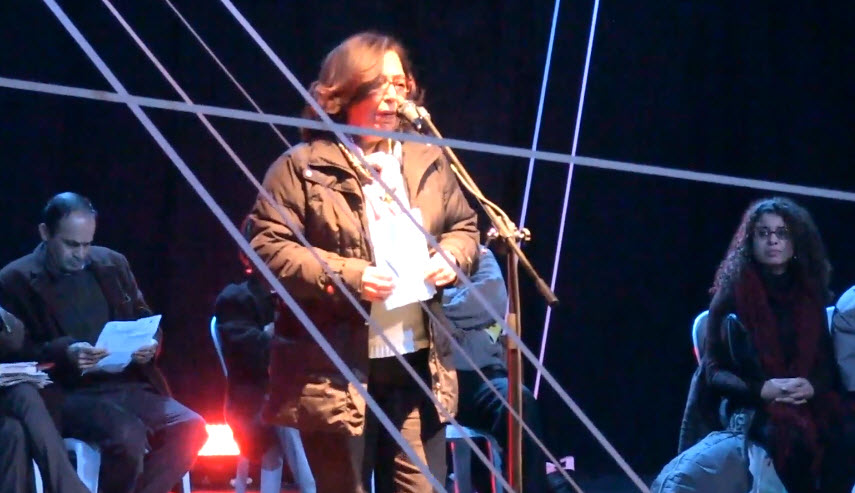تُنسى كأنك لم تكن
تنسى كمصرع طائر
ككنيسة مهجورة تنسى
كحب عابر
وكوردة في الريح
وكوردة في الثلج
تنسى…
محمود درويش
ما إن جلست على الكرسي حتى قالت بصوت هادئ يخفي وجعًا متراكمًا:” يُقال إن الذاكرة خائنة. يُقال إن الحكايات لا تروى كما حدثت، بل كما نتذكرها. ويُقال إن الكلمات تُعيد تشكيلنا حتى نكاد لا نعرف إن كنا نحيا أم نُكتب.” سحبت سيجارة ووضعتها بين شفتيها بيد مرتعشة والاخرى تبحث عن قداحة بعصبية في حقيبتها. الطبيبة لم تحاول منعها فواصلت البحث.
“الوحدة الحقيقية ليست في العزلة، بل في أن تحسب قلبًا مأوى، فإذا به مجرد محطة عابرة. والخذلان ليس في الفراق، بل في الذين يبقون بالجسد ويرحلون بالروح، يراقبون سقوطك وكأنك لم تكن يومًا سندًا لهم”. يئست اخيرا من العثور على القداحة فرمت السيجارة على المكتب وحدقت في الطبيبة قائلة “اليوم، لم أعد أبحث عن أحد، لم أعد أطرق أبوابًا موصدة. تعلمت أن أكون قوتي حين تخذلني الأيدي، أن أواسي نفسي حين يغيب الجميع، أن أكون الحضن الذي لم أجده في أحد.” قالت ذلك، أو ربما فكرت فيه، أو ربما قالته شخصية في رواية قرأتها ذات مساء. من يدري؟
أمامها، كانت الطبيبة تنظر إليها، كأنها تنتظر اعترافًا، أو جريمة تكتمل. وقاطعتها برفق “أنا هنا لأستمع إليكِ، لكن أحتاج منك وضوحًا أكثر… ما الذي أتى بك اليوم؟”
تنهدت بعمق، كأنها تفرغ ثقلًا ظل حبيسًا داخلها طويلًا، ثم قالت: ” يُقال إن الذاكرة خائنة لذلك، حين حاولت تذكر متى بدأ كل هذا، لم تجد نقطة بداية واضحة. ربما بدأت حين أدركت أن المرض ليس ما يقتلنا، بل غياب الذين كنا نظنهم درعنا. كنت أظن أنني محاطة بمن يحبونني حقًا، بمن يرون فيَّ أكثر من مجرد اسم في هواتفهم. كنت أظن أن السنوات التي أمضيتها إلى جوارهم، والأوقات التي كنت فيها سندًا لهم، ستعود إليّ حين أحتاجهم. لكنني كنت مخطئة… حين مرضت، لم أسمع أصواتهم، لم تصلني كلماتهم، لم أشعر بوجودهم. كنت وحدي في مواجهة الألم، وحدي في مواجهة الفراغ الذي تركوه خلفهم. لم يكن المرض ما أوجعني، بل تلك اللحظة التي أدركت فيها أنني كنت أعيش وهمًا كبيرًا، أنني كنت أستند إلى سراب. كنت أظن أن الألم بلغ ذروته حين أخبرني الطبيب أن المرض سرق جزءًا مني، استأصلوا ثديي وأنني لن أعود كما كنت. لكنني كنت مخطئة… كان هناك ألم آخر ينتظرني، خذلان لم أتصور أن يأتي من أقرب الناس إليّ.
حين وقف أمام القاضي يطالب بالطلاق للضرر، لم أحاول أن أوقفه، لم أسأله لماذا، لأنني كنت أعرف الإجابة. عرفتها منذ اللحظة التي عدتُ فيها إلى المنزل بعد الجراحة، نظر إليّ ببرود، ثم أشاح بصره بصمت. كنت أظن أن الحب لا يُقاس بتمام الجسد، بل بصدق المشاعر. لكنني كنت مخطئة. حين احتجت إليه، لم يكن هناك. كنت أبحث عن شيء واحد يبقيني متصلة بهذا العالم، لكنه انسحب كما لو أنني لم أكن شيئًا يُذكر. لم يكن المرض ما قتلني، بل إدراكي أنني لم أكن يومًا أكثر من دور عابر في حياته.
لذلك، رحلت في صمت. اختفيت من حياته كما لو أنني لم أوجد يومًا. لم أعد مجرد امرأة تركها، بل أصبحت غيابًا لا يمكنه الوصول إليه.”
مرَّ عام…
في تلك الليلة، حين رنَّ الهاتف، ترددتْ قبل أن ترد. لم تكن تظن أنه سيبحث عنها يومًا، لكن فضولًا غامضًا دفعها للرد.
— “مرحبًا؟”
كان صوته مختلفًا، ضعيفًا، وكأن الكلمات تتثاقل على لسانه: “أنا في المستشفى… قالوا لي إن السرطان انتشر… سأخضع لجراحة”… صمت لثانية و قال.. “استئصال.”
في تلك اللحظة، تجمدتْ، لم يسمع لها سوى زفرات متسارعة، وشيئًا أشبه بدموع مكتومة. انتظر ردها طويلًا، لكنها لم تقل شيئًا. ربما لأنها لم تكن هناك. أو ربما، لأنها لم تعد موجودة.
هل نحن الشخصيات في قصص الآخرين، أم أنهم مجرد شخصيات في قصصنا؟
واصل بصوت مرتجف: “لم أجد أحدًا… حاولت الاتصال بك، لكنك لا تجيبين.”
أغمضتْ عينيها للحظة، بينما كان قلبها يخوض معركة بين الماضي والحاضر. أخذتْ نفسًا عميقًا، ثم همستْ بصوت هادئ، لكنه محمّل بالكثير من الألم والعتاب “أنا واثقة أنها ستسهر على راحتك، وترعاك، وتحميك… لكن من مكانها.”
تنهَّدت والدتي التي أجابت على الهاتف ثم قالت بصوت خافت، وكأنها تكشف سرًا لم يكن يجب أن يظل مخفيًا :”من مكانها كنجمة في السماء.”
في الغرفة البيضاء، نظرت إلى الطبيبة، كأنها تبحث عن حكم أخير، بالعفو أو الإدانة لكل ما قامت به. ثم همست وكأنها تخاطب كاتبًا غير مرئي، أو قارئًا يظن أنه يفهم:
“أنا هنا، دكتورة، لأسألك… هل كنت قاسية حين تركته يعتقد أنني مت؟ هل كنت أنانية؟ أم أنني فقط تركته يتجرع ذات الكأس التي سقاني منها؟ هل نُنسى حقًا؟ أم أننا نعيش في الحكايات التي لم تُحكَ بعد؟”
رحاب عبد المقصود