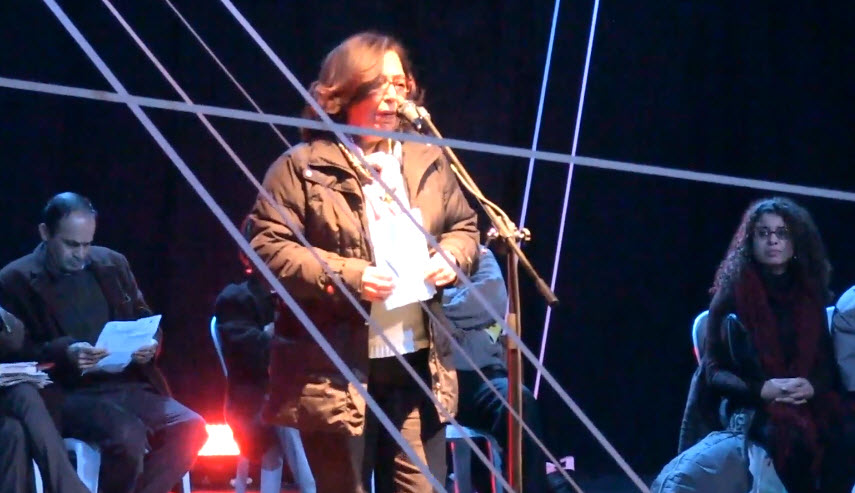السيّد “دافيد لوكونتور” فصل من رواية قادمة… لجلال الرويسي
"الأسماك تعزف على الكمان في قاع البحر."..

السيّد “دافيد لوكونتور”
ظهر دافيد لوكونتور في القرية بعد مغادرتي لها. جاءها متقفّيا لخطوات جدّه الذي عمل بالمنجم في السنوات الأولى لتأسيسه في بداية القرن العشرين. “لوكونتور” ليس لقبه العائلي بل اسم شهرة عُرِف به نتيجة عمله كحكواتي للأطفال في مكتبة المركز الثقافي الفرنسي. كان دافيد قد عثر في أرشيف جدّه على يوميات يتحدّث فيها بتفاصيل مثيرة عن حياة الناس في المنطقة عند اكتشاف الفسفاط وتأسيس المنجم. فقرّر أن يستثمرها في كتابة رواية بعنوان منجم في صحراء». هكذا تعدّدت زيارات السيّد “دافيد لوكونتور” إلى القرية حتى ألف الناس وجهه وأحبّوا حكاياته فصار يدخل بيوتهم وانتهى واحدا منهم. لاقت رواية «منجم في صحراء» بعد صدورها نجاحا واسعا وكان لها الفضل في التعريف بالقرية والمنطقة عموما. بعد تقاعده، فضّل السيّد “دافيد لوكونتور” العيش في القرية على العودة إلى فرنسا. أشهر إسلامه. اشترى البيت الذي عاش فيه جدّه ورمّمه ليقيم فيه. لم يكن هناك ما يشي بذلك الفصل المأساوي الذي انتهت به حياته في القرية.
لم يكن من السهل عليه أن يغادر القرية التي منحته السكينة والتركيز ونشّطت لديه القريحة ليكتب كلّ قصصه وينشرها في أشهر المجلاّت الأدبية. كان يكتب بالليل ويقرأ بالصباح. ينام متأخّرا ويصحو على الأذان فيخرج ليتمشّى رفقة كلبه في غبش الفجر… يتبادل تحايا الصباح مع المصلّين المستحثّين الخطى نحو المسجد. ثمّ يعود لينغمس في القراءة إلى غاية وصول خالتي فاطمة لقضاء شؤون البيت.
يدوّن ما تشير به خالتي فاطمة من لوازم الطبخ والتنظيف على ورقة صغيرة يضعها داخل قفّة السعف ويثبّتها في عنق كلبه. ثمّ يفتح له الباب كي يسير بهدوء في أنهج القرية حتّى يصل السوق، فيقف أمام الجزّار الذّي يتناول الورقة ويقرأ مستحقّات السيّد دافيد لوكونتور ثم يزن المطلوب ويضعه في القفة. ينتقل الكلب بعد ذلك إلى الخضّار الذي يفعل الشيء نفسه ثم الخبّاز فبائع الصحف وينتهي بدكّان المواد الغذائية ويؤوب إلى المنزل محمّلا بالبضائع المرصوصة في قفّة السعف بنفس الهدوء. وسائر خلق اللّه من أهل القرية يسبّحون منبهرين بتلك “الزايلة البكماء” يكادون يؤدّون لها التحية العسكرية من فرط الإعجاب والاحترام والرّهبة.
هكذا عاش السيّد “دافيد لوكونتور” سعيدا بالقراءة والكتابة في زهد يشبه حياة الرهبان. الكلّ يحبّه ويحترم عزلته ويحميه. لم يكن يزور بيته سوى خالتي فاطمة وسامي. كان سامي ولدا أبيّا يرفض أن يمدّ يده لأبيه ويحرص على أن يكون جيبه عامرا. لا يرفض أيّ عمل شريف يحفظ له كرامته. اشتغل نادلا ودهّانا وعتّالا ومدلّكا بالحمّام، إلى غير ذلك من المهن الصغرى، إلى أن استنجد به السيّد “دافيد لوكونتور” لمساعدته في ترميم بيته. فأعجب بتفانيه في العمل وأمانته، وصارا صديقين. كان السيّد “دافيد لوكونتور” لا يملّ من سامي وهو يحدّثه عن “الباشا” صديقه وعن اختلافه وتحليقه خارج السرب وجرأته في المجاهرة بشيوعيته.
هاجر سامي إلى إيطاليا دون أن يفي بوعده للسيد “دافيد لوكونتور” ويعرّفه بالباشا. حتى صادف أن حضر السيّد “دافيد لوكونتور” نقاش فيلم في نادي السينما، فانبهر بثقافة “الباشا” واطّلاعه الواسع على تاريخ السينما واتجاهاتها واستمتع بمناقشته. عند نهاية الحصّة، دعا السيّد “دافيد لوكونتور” الباشا إلى مواصلة النقاش في بيته. وكان ذلك بداية لصداقة استمرّت إلى يوم وفاة السيد “دافيد لوكونتور” بتلك الطريقة الغريبة.
كانت حياة السيّد دافيد لوكونتور بسيطة وهادئة حتّى جاء اليوم الذي بثّت فيه قناة تلفزية فرنسية حوارا معه تابعه أهل القرية بكثافة لمعرفة ما سيقوله عن حياته بينهم. لكن خالتي فاطمة جاءت بعد يومين تحذّره من وجود خطر يتهدّده بسبب ما صرّح به في الحوار. لقد تجاوز السيّد “دافيد لوكونتور” بالنسبة للملثّمين كل الخطوط الحمر لمّا جاهر بمثليته في التلفزيون. لم يشفع له عندهم اعتناقه للإسلام. فقرّروا إجراء محاكمة علنية له.
فكّر أوّلا في الانتحار حرقا، ولكنّه عدل عن ذلك…. اتّصل بسامي في إيطاليا يعلمه بما حصل، فطمأنه بأنّه قادم للوقوف إلى جانبه. لكنّ الملثّمين كانوا قد مرّوا إلى محاصرة البيت وصار من المحتمل أن يداهموه في أيّ لحظة. كان منهمكا في فرز أوراقه وجمعها لتهريبها مع خالتي فاطمة في انتظار وصول سامي، لمّا نبّهه نباح كلبه المهتاج إلى وجود أصوات خارج البيت، فأيقن أنّهم قرّروا مداهمة البيت. كان قد سلّم صباح ذلك اليوم خالتي فاطمة رسالة إلى أهل القرية يشرح فيها موقفه، ووصية تكليف “الباشا” بتحويل بيته بما يحويه من كتب ووثائق إلى مكتبة عامّة. فقد تركيزه ولم يعد قادرا على مواصلة الفرز. وصار يتخيّلهم وهو يدفعون الباب وينصبون له محكمة. “لكن لا، لن أتركهم يفعلون بي ما يريدون. الانتحار أفضل لي من أن أقف متّهما بين أيديهم، عاجزا عن إقناعهم بالحق في الاختلاف”. أطلّ من كوّة الغرفة العلويّة، فلمح جمعا من الناس يتفاوضون همسا. نزل الدرج الخشبي وهو ينطّ مرتجفا قاصدا المطبخ حيث الولاّعة. كانت الأصوات في الخارج قد علت وصحبها طرق على الباب… حاول أن ينهي بقية درجات السلّم بنطّة واحدة فإذا كعبه يلتوي فيتهاوى متدحرجا نحو الأسفل…. لمّا خلع الجماعة الباب ودخلوا وجدوه في حالة غيبوبة والكلب يلعق جبينه… انحنت خالتي فاطمة عليه تتفقّده، فوجدت خيطا من الدم يسيل من أذنه. ولم يكن بإمكان المركز الصحّي بالقرية فعل شيء لإنقاذه من النزيف الدماغي. كانوا يريدون من وراء محاكمة السيّد “دافيد لوكونتور” التي انتهت بذلك الشكل المأساوي قبل أن تبدأ فرض وجودهم نهائيا كسلطة موازية للسلط الرّسمية، تأمر وتنهى وتؤدّب من يتمرّد على نواميسها.
لمّا عاد من الجنازة، اكتشف سامي أنّه فقد حافظة أوراقه بما فيها من وثائق شخصية: جواز السّفر وبطاقة الإقامة في إيطاليا، وبطاقة البنك وأوراق السيارة وبطاقة التغطية الصحية… ستتعطّل حياته بالكامل في غيابها. لا سفر ولا سحب للأموال ولا استخدام للسيارة ولا علاج، ولا شيء مطلقا. فكّر أن يستفتي إمام المسجد في فتح القبر. وعندها لن يبقى له سوى استصدار ترخيص بذلك من السلط الإدارية. ولكن، من يضمن أنّ الإمام سيجرؤ على فتح فمه أصلا بعد الذي حصل؟ لو كان شجاعا لتحدّى الجماعة وخرج إلى الصّلاة على الميّت وأشرف بنفسه على مراسم الدفن كما تعوّد أن يفعل. كان الجماعة قد اعترضوا على دفن السيّد “دافيد لوكونتور” في مقبرة المسلمين. فلم يخرج في جنازته إلاّ سامي والباشا والمنصف وكلب السيّد “دافيد لوكونتور” اقشعرّ جلده رعبا لمجرّد أن راودته فكرة نبش القبر بنفسه خلسة ودون إعلام أحد. فهذه مغامرة غير مضمونة العواقب. فمن سيصدّق روايته لو اكتشف أحدهم الأمر؟ في الأخير اهتدى إلى أنّه لا خيار له سوى إعلام مركز الحرس الوطني، وهم سيجدون له حلاّ… نعم، سيكتفي بإبلاغ السلطة دون إفشاء الأمر بين الناس، وعندها سيتخفّف من العبء الذي سينتقل من على كتفيه وضميره إلى مكاتب السلطة وملفّاتها… مرّ إلى التنفيذ بسرعة مخافة أن يغيّر رأيه من جديد فتستبدّ به الحيرة. أفاده رئيس مركز الحرس الوطني أنّ عليهم طلب إذن بفتح القبر من النيابة العمومية وأنّ الأمر قد يستغرق أسبوعا. في الانتظار، واصل حياته عاديّة عملا بنصيحة رئيس المركز حتى لا يلاحظ عليه أحد أيّ تغيّر. واتّصل بشركة الطيران ليؤجّل موعد عودته إلى إيطاليا. كما أخبر زوجته الإيطالية أنّه مدّد إقامته في تونس لأنّه لم يشبع من الأهل والأصدقاء الذين غاب عنهم طويلا. فرح سامي لمّا جاءه عون الحرس باستدعاء إلى المركز، وفهم أنّ الترخيص بفتح القبر قد وصل ومعه الخلاص من الورطة، فسارع إلى مرافقة عون الحرس. لكنّ رئيس المركز أعلمه أنّهم اتّصلوا بالترخيص من يومين وقاموا بفتح القبر ليلا فلم يجدوا لا حافظة أوراقه ولا الجثة أصلا. ولم يصدّق أذنيه لمّ قال له رئيس المركز: “أنا مضطرّ للاحتفاظ بك على ذمّة التحقيق”. لمّا فتح شرطي الاستمرار باب الزنزانة على سامي في مساء نفس اليوم، فوجئ بالمنصف ولد الحاج يونس يلوي ذراع الشرطي إلى الخلف ويخاطبه: ” أنتم تعرفون جيّدا من نبش القبر وأخفى الجثّة. لماذا تتركونه طليقا وتحمّلون هذا الرجل ذنبا لم يرتكبه؟”… ثمّ ألقى بحافظة الأوراق عند قدمي سامي وطلب منه أن ينصرف قبل أن يدخل الزنزانة مكانه ويأمر الشرطي بإغلاقها عليه.. ردّد الشرطي موافقا: “الله يبارك سي المنصف”.”
عاد سامي إلى إيطاليا، وظلّ أصحاب الجلابيب طلقاء يفرضون سلطانهم على الناس فيدينون لهم بالولاء والطاعة. لم يشذّ عن ذلك إلاّ الباشا الذي كان كلّ مساء يصرخ طوال طريق العودة من “بلحاج” إلى بيته “سنحاسبهم، سنلاحقهم” ويبصق رافعا إصبع الاتهام في الهواء. ويصرف صباحه في تسوية الأمور الإدارية لتحويل بيت صديقه “دافيد لوكونتور” إلى مكتبة عامة. وها هو يقترب من تنفيذ الوصية وتحقيق حلم صديقه. كان قد كتب إلى مجيد يحدّثه عن رغبته في جعل حفل التوقيع على روايتي أوّل حدث تدشّن به المكتبة العامة “دافيد لوكونتور” نشاطها. وقد لاقت فكرته حماسا ودعما لدى مجيد والمنصف وريم وسي علي وسامي الذي وعد بالقدوم من إيطاليا بعد سنوات الغياب منذ وفاة السيّد “دافيد لوكونتور” وما صاحبها من تقلبات. في ذلك الفجر، رتّب الباشا أوراق الملف داخل حقيبة ظهره، ودسّ القارورة المعدنية ذات الحزام الجلدي في جيب الحقيبة الخارجي. ثمّ أدار المفتاح في القفل وتوجّه إلى المحطّة. كان مسافرا إلى مدينة قفصة لإتمام إجراءات فتح “مكتبة لوكونتور العامة”. كان الباشا يحب السفر في قطار الثالثة فجرا رغم تطوّر العصر وتكاثر وسائل النقل وتنوّعها. فقد ظلّ وفيّا لهذا القطار لا يرضى له بديلا رغم ما يميّزه من بطء وتأخيرات. قطار الثالثة فجرا يذكّره بأيّام الدراسة زمن كان وسيلة النقل الوحيدة التي تربط القرية بمدن الشمال. له فيه ذكريات لا تمّحي. وظلّت رائحة خشب المقاعد الهرمة معشّشة في جيوب أنفه، كما لم ينس إيقاع العجلات الحديدية الرتيب وهي تنزلق فوق عمودي الفولاذ الممتدّين كثعبان. هناك فقط يمكنه أن يسمع تلك الصافرة المبحوحة التي تصل الأمس باليوم فتبقي على الذاكرة حيّة.
لفعته نسمات الفجر الباردة فنشّطته وجعلته يحث الخطو لتجاوز الزقاق الضيّق المظلم والوصول إلى الشارع الرّئيسي المضاء. لم يكن يدري أنّهم سيعترضونه في ذلك المكان وفي ذلك الوقت، كما لو كانوا في انتظاره. حدس أنّ خطرا يتربّص به ما إن لاحظ أحدهم يتقدّم نحوه فيما تأخّر البقية، وكانوا جميعا حريصين على تغطية وجوههم بطرابيش برانيسهم. بادره الشخص المتقدّم نحوه وهو يسدّ عليه الطريق: “وين على خير؟ ما تقولّيش ماشي تصلّي الفجر حاضر، في بالنا بيك شيوعي ثابت على المبدأ”. لمعت في ذهنه جملة مظفّر النوّاب “في الرياح السيّئة يعتمد القلب”، وقدّر أنّ له أولويّتان: الأولى هي أن ينقذ الحقيبة والثانية هي أن يستدرج مخاطبه إلى مزيد من الكلام عساه يتعرّف عليه من صوته في انتظار أن يتبيّن مسلكا للنّجاة. ألقى بالحقيبة خلف الجدار المحاذي فوقعت في حوش ريم. وواجه محدّثه: “ما الذي تريدونه منّي؟ أنا لا أعرفكم، تنحّوا عن طريقي”. لكنّهم انهالوا عليه ركلا ورفسا. لمّا فتحت ريم بابها وأطلقت كلبها الضخم أطلقوا سيقانهم للرّيح… كان الباشا طريح الأرض والدم ينزف من وجهه، حين التحقت به. دعته إلى داخل منزلها حتى تضمّد جراحه بعيدا عن أنظار مصلّي الفجر، فلم يمانع… مدّدته على فراشها ونظفت وجهه من الدماء وكمّدت الكدمات الزرقاء. اعتذرت ريم عن سوء ترتيب البيت وبساطته وأخبرته أنّ نفس الجماعة زاروها قبل أسبوع ليدعوها إلى التوبة ويعرضوا عليها السفر إلى بلاد الجهاد فهذا كما قالوا لها أحفظ لشرفها وأوفر كسبا. ناولته حقيبته وقالت: “دقيقة، سأعدّ قهوة ساخنة على السّريع وأعود”. ولكنّ الباشا أمسكها من معصمها وسحب القارورة المعدنية من جيب الحقيبة ثمّ قال لها “أفضّل جرعة بوخا في هذا البرد.” وعرض عليها أن تشرب منها إذا كانت ترغب في شيء من الدفء. ابتسمت ريم وردّت بتنهيدة مثيرة: “الدفء؟ لا دفء لامرأة واطئة الجدار” ثمّ أضافت بدلال وهي تمسح على ظهر كلبها الذي أقعى بجانبها “لا تؤاخذني يا أستاذ، فأنت ما شاء الله مثقّف وتفهم كل شيء… أنا لا أجد دفئي إلاّ في هذه “الزّائلة” البكماء التي تحميني من الكلاب البشرية”.
لمّا رفع المؤذّن صوته مناديا لصلاة الفجر، أطلق القطار صافرته المبحوحة معلنا انطلاقه، وانتفض كلب ريم يتفاعل بنباح حاد ومتواصل. وتمتم الباشا “فعلا، القطار لا ينتظر أحدا”.” مات الباشا بعد هذه الحادثة بيومين، قبل أن يحاسب قتلة السيد “دافيد لوكونتور” وينفّذ وصيّته. نام ولم يستيقظ. كان موتا سرياليا يشبهه وظلّ ندمانه من عمّال الداموس والصعاليك يردّدون بنوع من التقديس ما حفظوه عنه من أقوال كان يلقي بها في الهواء لمّا ينتشي كحمم يلفظها بركان وهو يقهقه كرعد هادر: “البقر يتربّع على أعمدة الكهرباء ويلعب الدومينو” و”القبّعة تتزوج المكنسة في منتصف الشارع” و”الساعة تبتلع جناح فراشة وتعلن منتصف الليل” و”القطارات تنام في جيوب الأطفال.” و”الأسماك تعزف على الكمان في قاع البحر.”..