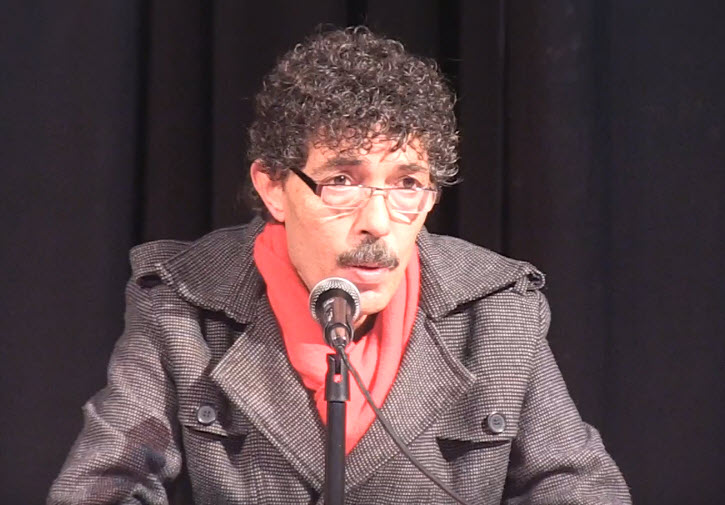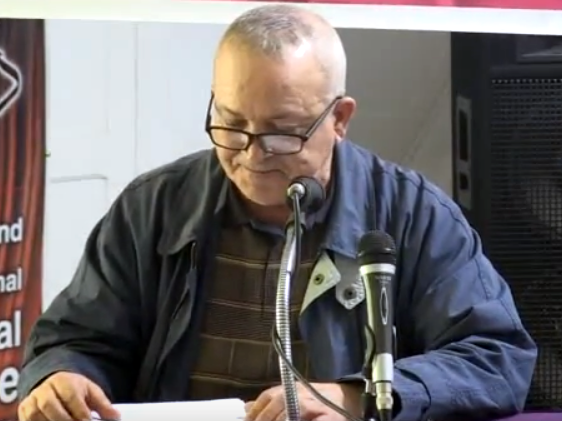مُنْتَصَفُ النَّهَار أو اللَّحْظَةُ الصِّفْر. لمحمد مومن
ها أننا قد وصلنا إلى خاتمة الرحلة التي قمنا بها في عالم ” العَابِرِ للإنْسَنِيَّةِ ” و ” مَا وَراء الإنْسَيَّةِ “. إنه آخر مقطع من المقالة التي كتبتها في الموضوع سنة٢٠١٧ . المقالة انتهت، ولكن الجدل حول هذا التيار يستمر…
بعد أن كان الله الخالق هو من يُسَيّرُ ويُدَبِّر مصير الكون ” عَهَدَ ” إلى الإنسان أمر ولايته ورعايته، حسب ما تصوّره عَهْدُ النهضة أواخر القرون الوسطى. ” اِنْسَحَبَ ” مِنَ الكوْنِ مَنْ كانَ كَوَّنَهُ ، كما كانوا يقولون، تاركا إياه إلى كائنه البشري يتولى شؤونه كما شاء واشتهى. فما الذي حدث؟ ما حدث هو أننا صيَّرنا اللاَّهُوتِيَّ علمانيا والإِلاهيَّ انسانيا والروحانيَّ ماديا. أصبحت رؤيتنا للحياة شيئا فشيئا ” أُفُقِيّةً “، أي مُسطَّحة مُنبَسِطة، دون تضاريس تُذْكر، وقد كانت من قبل ” عمُودِيّةً ” مَرَاتِبِيَّة وبالتالي، وبصورة من الصور، تَفاضُلِيَّةً. لم يعد هناك سُلّم درجات.
ما حصل إذن هو انقلاب تام في الرؤية، حيث تساوت القيم وتشابهت المبادئ، وإذا الأفكار تعادلت والمثل تماثلت والنظريات تقاربت. إن هذا هو كما يراه “نيتْشَة ” بعيونه الشاعرة الحالمة ” مُنْتَصَف النَّهَار “: لحظةٌ نَاصِعٌ بَيَاضُهَا سَاطِعٌ نُورُهَا، تبدو الأشياء والكائنات فيها قد تَسَاوَتْ وظِلالَهَا. إن الحداثة، في صورة من الصور، هي ” مُنْتَصَفُ النَّهَار ” ذاك، لمّا تلمعُ لحظته في ما يقلّ عن رمشةِ عينٍ قبلَ الظهيرةِ، وفي ذروة نهاية نهايات الصّبِيحَة، في آخرِ لحظةٍ تقصرُ مدّتُها عن لمحِ البصرِ، قبل فواتِ الضُّحى وانتصافِ النّهار وتَساَوِي الشّمْسِ في الّسماءِ. وهو من وجهةِ نظرٍ أخرى، إن شئنا وكما شاء ” نِيتْشَة “، “نِيتْشَة” دائما، ” مُنْتَصَف اللَّيْل “، وبالتّحديد زمن حلوله : لحظته ليست كاللّحظات حيث لا يمكن توصيفها أو نعتها، مسكها أو حصرها لأنها لحظةُ ” صِفْرٍ “، صفر ” مِنَ ” الزمن لأنها بين لحظتَيْنِ، لحظةٌ مضت وأخرى ما أتت بعد؛ فهي ” بَيْنَ بَيْنَ ” كما كان سيقولها طه حسين لو كان عليه أن يقولها، أو ربما لم تكن هكذا، في منزلة بين منزلتين، بل في منزلَةِ ” اللاَّمَنْزِلَةِ “: إنها صفرٌ ” فِي ” الزمن. هي طبعا ليست لا شيئا أو إن شئنا لا شَيْءَ الشَّيْءِ وإنما شَيْءَ الاَ الشَّيْءِ أو كما لو شاء ” فْلاَدِيمِيرْ يَانْكِيليِفِيتْش ” تسميتها لسماها ب ” مَا يَقْرُبُ اللاَّ الشَّيْء “. بكلام آخر أقل تجريد، نحن نعيش لحظة حضارية تأبى ” التَّنْزِيلَ “. إننا أقرب ما يكون إلى منطق ” البَيْنِيَّةِ “. فمن ناحية ” التَّوْصِيفِ “، هي خارج الأوصاف والنعوت، ومن زاوية ” التَّقْيِيمِ “، هي ما بعد الأخلاق أو ما بعد الخير والشر.
من الصعب أن ننكر أن ” مَا بَعْدَ الحَدَاثَةِ ” سعت إلى التصالح مع الأخلاقيات معيدة النظر في القيم لا كمفاهيم ثابتة ولكن كمبادئ سائِرةٍ سائِلةٍ علينا دوما إبداعها. للأخلاقيات آفاق جمالية. ومنطقها، خلافا لما نظن، إبداعي. وحده قِصَر النظر يوهمنا أن الأخلاق لا تنبت ولا تنمو إلا في أرض لا تتنفس إلا الإيجابيات ولا تترعرع وتزدهر إلا متى عميت على السلبيات فتجاهلتها وتناستها. والحقّ أن للحقيقة وجه آخر، وهو في اتجاه معاكس تماما لهذا الفهم البسيط، أو قُلْ الساذج، للأخلاق : منذ تَجَمَّعَ على الأرض البشر، لم تكن الأخلاق غيرَ صراعٍ بين الخير والشر، بين المُشْرِقِ والمُظْلِمِ من الحياة، نعم. لهذا ما كان المسرح يوما سوى صراعا لا يَمِلُّ ولا يَكِلُّ ضد قوى الشر حتى وإن كانت هذه القوى تتبدل وتتغير في أشكاها وصفاتها من عصر لعصر. ربما تبدّلَ الشّرُّ شكلا ولكن مضمونه ومحتوَاه، وجودَه كمبدإٍ عامٍّ أو كَقَاعدةِ تعامل الناس مع الناس، أثْبَتُ. هو لا يمَّحِي. من أجل هذا، وبسبٍ من غير هذا، يمكننا أن نتساءل إن أتى حينٌ من الدهر لم يكن المسرح فيه حقا غيرَ فنِّ ” الكوارثِ ” و ” المصائبِ “؟ الحقيقة أن منذ نشأته الأولى وهذا الشكل التعبيري ما فتئ يقص علينا أحسن القصص التي ترشح بالمآسي والفواجع واﻷزمات. ولنراهن إذن أنه لن يخلف وعده القديم وسيحكي لنا حكايات زمن الإنسان تحت سماوات عوالم ” العَابِرِ للأنْسَنِيَّة ” و ” مَا بَعْدَ الأَنْسَنِيَة “.
ليس حَرِيٌّ بنا إذن أن نتساءل إن كان حقا المسرح فنًّا تَبْشِيرِيًّا. متى كان المسرح شحيحا في التغنى بالحياة السعيدة والمدن الفاضلة والبشرية لحظة تجلي ملائكيتها؟ ألم يكن دوما نصير الخير والعدل؟ ومتى لم يكن منتصرا للحب والحرية محاربا ضدّ الشر والظلم والاستعباد والكراهية؟ أليس هذا من الحقائق الشائعة المتفق عليها؟ فهل يمكننا أن نحلم بمسرح حقيقي دون أن نكون قد حلمنا ونحن في تمام يقظتنا بهذه المثل العليا؟ من يمكنه أن يشك لحظة أن هذا الفن، منذ فجره الأول، قام نصيرا لكل القيم الفاضلة السامية ولم يعدل طيلة مسيرته الطويلة والعسيرة عن نشرها في الدنيا؟ من زاوية النظر هذه، يبدو المسرح شمسا يشعُّ نورها على الأرض، في صراع أبدي، يكاد يكون أنْطُولوجيا، مع قوى الظلام. من يشك أن المسرح لا يتردد أبدا عن الوقوف في صف الإنسان وفي جبهة الإنسانية؟ أليس هذا من بين الحقائق الثابتة التي يؤكدها تاريخ المسرح على مر الزمن؟ فَتُرى مَن لا يَرى أن مثل هذه المبادئ والغايات مما لا يُنَاقَشُ؟ وبالفعل، فهل رأينا من ناقشها؟
إن المسألة الحقيقية ليست بالتحديد هنا، وإنما بالتأكيد في مواضع أخرى. هي – مثلا – في السؤال القلق حول ما يمكن أن يفعله الفن المسرحي في عصرنا الراهن، في هذا الزمن ” الأَنْسَنِيَّ ” المعلن ؟ وفعلا، انشغالنا الأكبر، نحن أبناء هذا الوقت الصعب الموسوم بعهد ” الفَوْضَى الخَلاَقَة “، هو بمدى قدرة الفن الدرامي – الحي- على المقاومة، أي كما يريد ذلك ” جِيلْ دِي لُوزْ “، على الإبداع والخلق لا الإتّباع والنّسخ. كيف سيستطيع المسرح أن يقاوم، أي كيف سيخلق نفسه من جديد، ويجد القدرة على التجدّد والتّجديد؟ وما معنى أن ” يَتَجَدَّدَ المَسْرَحُ ” أصلا؟ ولكن هل يمكننا أن ننسى أن حياة المسرح رهينة حياة الإنسان؟ سيبقى هاجسنا في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البشرية الجواب عن السؤال الأهم الذي لا سؤال أهم منه : نعم، هل سيستطيع الانسان أن يُخَلِّصَ الإنسان من براثن الإنسان وجنونه فيُغَيِّر ما به ويُبَدِّل قَدَرَهُ؟ صحيح أن الإنسان نجح قديما في التَّأَقْلُمِ مع الظروف والمعطيات الطبيعية واللاَّطَبيعيَّة، ولكنه ها هو في زمننا الراهن يجد نفسه في منعرج حاسم لم يعرفه من قبل ولن يعرفه مستقبلا أبدا إن لم يصب الاختيار، ذلك أن مصيره سيَتَقرَّر حينئذ نهائيا : إنها بالنسبة إليه حكاية حياة أو موت، قضية وجود : أن يكون أو لا يكون، أن يبقى أو لا يبقى على وجه اﻷرض، علما أنه لم يحسن التعامل مع الطبيعة فكان معها من العَادِينَ. ربما سيكون الذكاء البشري، ما سمّاه البشر ” الذَّكَاءَ البَشَرِيَّ ” (ولكن من هو الذي ما زال يُسَلِّمَ بهذا ” الذَّكَاءَ “؟)، سببا في دماره، بل في فنائه واختفائه من على الأرض.
الخطأ القاتل أن نظن أن الإنسان بمنأى عن مثل هذا المصير التَّعِس النَّحِس. إنه ميت وحضارته ميتة، وهي حقيقة يرفض أن يقبلها الفكر ” العَابِرِ للإِنْسَانِيَّةِ “. غير أن رفض الموت من الإنسان ليس جديدا وإنكاره حقيقة الفناء والزوال قديم قِدَمَ العالم والإنسان، قديم قدم الموت نفسه، أقدم من جِلْجَاِمشْ الرمز الخالد لرغبة الخلد. وأن تَرْفُضَ المَوْتَ، هل يعني حقا أنك لن تموت؟ الطبيعة ميتة والإنسان ميت والمسرح ميت. فهل لا تستوجب هذه الآفاق السوداء الحذر والسهر على إبقاء ما هو حيٌّ حَيًّا. إن ما يجعل الأمل قائما أن هذا الثالوثَ هشٌّ، رقيقٌ، ضعيف، عرضةٌ لجميع أشكالِ الإبادةِ وقّوى الاضمحلالِ. إنه فريسةٌ سهلة؟ للموت والفناء. ولكن هذا الضُّعف – وقد يبدو هذا من المفارقات – هو الذي سيمكِّنٌه من النجاة – إن كانت هناك نجاةٌ. فالضعف هو الذي سينقذ الإنسان والطبيعة والفن. يمكننا، لما لا، أن نأمل في بصيص نور، مهما كان ضعيفا، نرى فيه ضعف الثالوث هذا يتحوّل إلى قوَّةٍ حيث أنها تدفع بمن يسعون إلى زرع قيم ” العَابِر للأَنْسَنِيَّةِ “، ومبادئ ” مَا بَعْدَ الأَنْسَنِيَّةِ ” كي يفكروا أكثر في الآفاق الأخلاقية والروحانية لمشروع الحضارة التي يَعِدوننا أو يتواعدوننا بها. فهل يتواصل نسيانُ القِيَمِ والمثلِ الإنسانيةِ حتى نصير نَسْيًا مَنْسِيًّا؟ المستقبل ليس بالوَرْدِيِّ، أكيد، ولكن من قال إن هناك شيئا مستحيلا؟ ما علينا أن نتذكر لنعيد ما قاله ” لِيوُنْ بَاتِيسْطَا ألْبَارْتِي “عندما تنسدُّ أمامنا الآفاقُ : ” لَوْ شَاءَ الإنْسَانُ أَنْ يَفْعَلَ كل ما يشاء لَفَعَلَ”. فهل سيفعل؟ هل ينقذ بنو آدم الإنسانيةَ والحضارةَ والفنَّ والمسرحَ؟ ولكن ربما استطاع المسرح إنقاذ الجميع وكل شيء؟ بعضهم يرى هذا بعيدا مستحيلا ونراه نحن ممكنا قريبا.